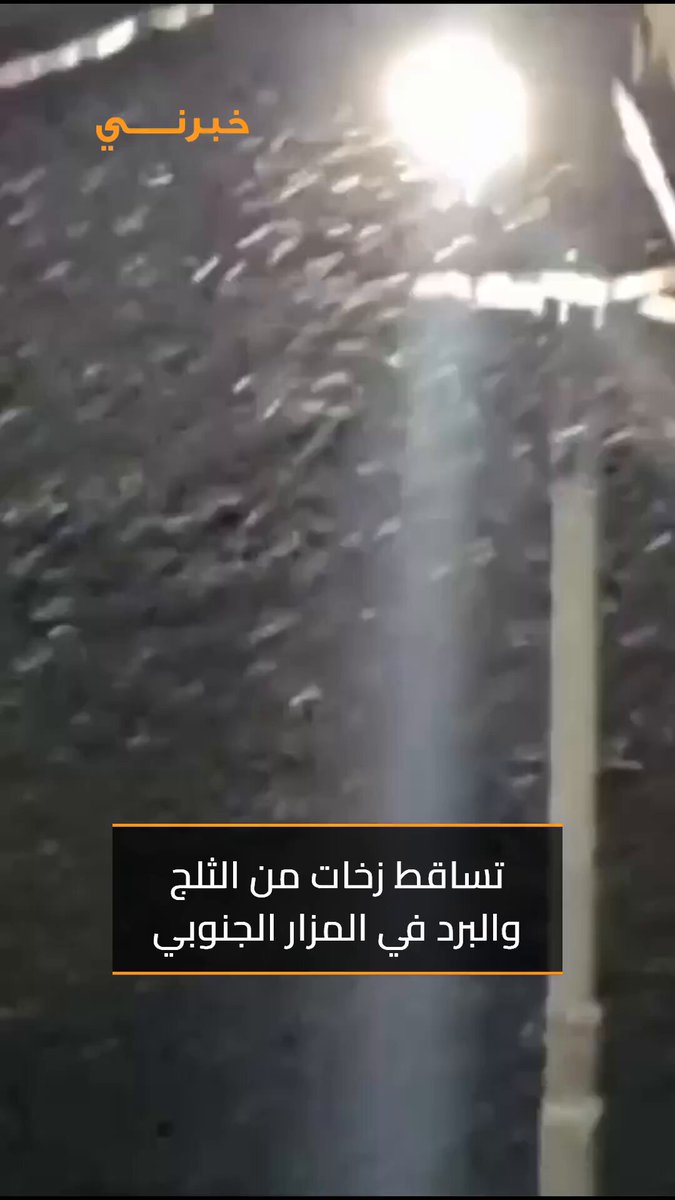ترجمة: علاء الدين أبو زينة مقدمة
سوف يجد الناظر في المشهد الدولي اليوم أن الجدل حول صراع القوة بين الولايات المتحدة والصين لم يعد يدور حول حجم الأساطيل والمدرعات أو عدد القواعد العسكرية. لقد أصبح هذا منظورًا ينتمي إلى الماضي. الآن، تُصاغ القوة في القرن الجديد في فضاءات جديدة هادئة لا تثير الكثير من الضجيج الإعلامي، لكنها تُعيد رسم قواعد النظام العالمي. بدلًا من ساحات النفوذ التقليدية، أصبحت أعماق البحار، والممرات القطبية، والمدارات الفضائية، والبنية التحتية الرقمية، وأنظمة الدفع والاتصال والتقنية هي خطوط التماس الفعلية بين واشنطن وبكين. ولذلك تتباين التقديرات: بينما يعتقد البعض أن القوة العسكرية الأميركية الهائلة تضبط الصين، يرى آخرون أن بكين تتحرّك بهدوء وذكاء، وتُراكم عناصر نفوذ تجعلها أقرب إلى أن تكون المهندس الفعلي للنظام الدولي المقبل.
ربما كان هذا الإدراك الجديد هو الذي دفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الإعلان في الحادي عشر من هذا الشهر عن إنشاء تحالف دولي جديد باسم "سلام السيليكا" أو "سلام أشباه الموصلات" Pax Silica. ويضمّ هذا التحالف سنغافورة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل، ويهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الصناعي، والتصدّي للهيمنة الصينية في هذه المجالات من خلال تقوية التعاون في البحث والتطوير والتصنيع والبنية التحتية الحيوية.
أدركت الصين مبكرًا أن النفوذ العالمي لم يعد يُصنع من فوهات المدافع أو معدلات النمو وحدها. وأن القوة الحقيقية أصبحت تتعلق بالقدرة على الوصول إلى الموارد النادرة في قيعان البحار، وتأتي من بناء أنظمة ملاحة واتصال خاصة، ومن التحكم في الإنترنت وسلاسل التوريد، ومن صياغة المعايير التي تنظم التكنولوجيا والمؤسسات الدولية. ولذلك ركّزت الصين على مدى العقود الماضية على ساحات لم تُولها القوى التقليدية اهتمامًا كافيًا: التعدين في أعماق المحيطات، والملاحة عبر الممر القطبي الشمالي، والشبكات الفضائية المتقدمة، والكابلات البحرية، وبناء بنى تحتية رقمية تُستخدم في التجارة، والدفع الإلكتروني، وتبادل البيانات.
وهكذا، إذا كانت الولايات المتحدة تراهن على أن يكبح تفوقها العسكري صعود الصين، فإن بكين تعتمد نهجًا مضادًا تمامًا: التوسع الصامت. وكما يقول كاتبا المقال أدناه، لم يكون رسو سفينة صينية في ميناء فيليكسستو البريطاني في الشهر الماضي قادمة عبر طريق تجاري جديد يمر بالمحيط المتجمّد الشمالي مجرد نجاح لوجستي، وإنما كان رسالة بأبعاد جيوسياسية عميقة. لم تعد الصين تلتزم بالمسارات التي رسمها الآخرون، وأصبحت تشقّ لنفسها طرقًا تجارية وتقنية تُعيد تعريف قواعد الحركة والتبادل. وقد وصفت بكين ذلك بأنه مساهمة في استقرار سلاسل التوريد، لكن العالم قرأه كمؤشر إلى انتقالها من لاعب ينافس إلى لاعب يعيد رسم الخريطة.
ولم يكن هذا التوسع اندفاعة مفاجئة بقدر ما جاء نتيجة تخطيط عميق بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي. وقد أدرك الاستراتيجيون الصينيون في تلك الفترة المبكرة أن الهيمنة على "حدود القوة-من المحيطات إلى الفضاء الخارجي، ومن البيانات إلى الأنظمة المالية- ستمنح بلدهم قدرة على رسم المشهد العالمي لاحقًا. ولذلك بنت الصين منظومة متكاملة: مؤسسات مختصة، كوادر علمية، تكنولوجيا متقدمة، اختراق للمؤسسات الدولية عبر التمويل والخبراء، وتأسيس منظمات بديلة حين يتعذّر تعديل القواعد داخل المؤسسات القائمة. وقد تركت هذه المنهجية القائمة على الصبر التراكمي الصين وهي تُمسك اليوم بأطراف متعددة في شبكة القوة العالمية، من البحار إلى الفضاء، ومن أنظمة القياس إلى فضاءات البيانات.
في المقابل، تعاملت الولايات المتحدة مع المشهد بمنظور ضيق، ينشغل بأعراض التنافس وليس بجذوره. وبينما انصبّ النقاش الأميركي العام على الرسوم الجمركية، وحرب الرقائق، والقيود على الشركات، والتوترات الدبلوماسية،كانت الصين تعمل بعيدًا عن الضوء، داخل اللجان الفنية للمؤسسات الدولية، وفي المختبرات الثقيلة، وفي مشاريع البنية التحتية العابرة للقارات. وبينما ظنت واشنطن أنها ستتمكن من احتواء الصين بالعسكر والاقتصاد، كانت بكين تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة: الانتقال من قوة صاعدة تجاريًا ضمن قواعد النظام الدولي إلى قوة تشريع قادرة على كتابة قواعد النظام القادم.
ربما تكون هذه الفجوة بين القوتين هي مفتاح فهم السجال حول مَن يقود ومَن يتبع. لم تسع الصين إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة، واعتنقت بدلًا من ذلك استراتيجية من "التجاوز الصامت"، التي تقوم على بناء القدرات التقنية والعلمية، ونسج الشراكات، والتأثير في المؤسسات، وخلق بدائل عن النظام الدولي عندما يصعب تغييره من الداخل. وقد منحها هذا النمط تفوقًا نوعيًا: إنها تتجنب الصدام، لكنها تُراكم تأثيرًا يسمح لها بإعادة تشكيل نفس البيئة التي تُمارس فيها القوى التقليدية نفوذها.
وإذن، هل تستطيع الولايات المتحدة ردع الصين عسكريًا؟ يبدو هذا السؤال خارج السياق، بما أن الصين لا تسعى إلى اختبار التفوق العسكري الأميركي، وإنما إلى تجاوزه عن طريق إعادة تعريف ساحات القوة. وإذا كان النفوذ في عالم اليوم يتحدد بمن يمسك بالبنى الرقمية والفضائية والقطبية والمالية، فربما تكون بكين هي التي تُمسك بمفاتيح النظام المقبل، وتجعل حجم الأساطيل الأميركية غير ذي صلة. (بل إن تقديرًا أمنيًا أميركيًا صدر هذا الأسبوع رأي أن الولايات المتحدة لا تستطيع التغلب على الصين عسكريًا أيضًا، بل العكس).
إذا كان ثمة شيء في هذا التحوّل، فإنه يكشف عن أن الصراع الأميركي الصيني لم يعد تنافسًا على التجارة أو التقنية بقدر ما هو معركة على صياغة مستقبل النظام الدولي نفسه. ومع استمرار الصين في بناء نفوذها في "الحدود الجديدة للقوة"، يترتب على الولايات المتحدة، والعالم معها، أن يتعاملوا مع حقيقة أن بكين لم تعد قوة صاعدة، وإنما أصبحت قوة تعيد رسم الحدود ذاتها التي تُقاس بها حدود القوة.
إليزابيث إيكونومي - (فورين أفيرز) 9/12/2025
عندما رست سفينة الشحن الصينية "إسطنبول بريدج" في ميناء فيليكسستو البريطاني في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، ربما بدا وصولها غير لافت؛ فالمملكة المتحدة هي ثالث أكبر سوق للصادرات الصينية، والسفن تتنقل بين البلدين طوال العام.
لكن ما كان لافتًا في "البريدج" هو المسار الذي سلكته. كانت أول سفينة شحن صينية كبرى تسافر مباشرة إلى أوروبا عبر المحيط المتجمّد الشمالي. وقد استغرقت الرحلة 20 يومًا، أي أسرع بأسابيع من الإبحار عبر الطرق التقليدية مثل قناة السويس أو حول رأس الرجاء الصالح. وقد اعتبرت بكين الرحلة اختراقًا جيوسياسيًا ومساهمة في استقرار سلاسل التوريد. ومع ذلك، كانت الرسالة الأهم غير مُعلنة: اتساع مدى الطموحات الاقتصادية والأمنية للصين في مجال جديد من مجالات القوة العالمية.
وليست مساعي بكين في القطب الشمالي سوى قمة جبل الجليد -بالمعنى الحرفي والمجازي. منذ خمسينيات القرن الماضي، ناقش القادة الصينيون التنافس في حدود العالم الحرفية والرمزية: أعماق البحار؛ القطبان؛ الفضاء الخارجي؛ وما وصفه الضابط السابق في جيش التحرير الشعبي، شيو قوانغيو، بـ"مجالات النفوذ والأيديولوجيا"، وهي مفاهيم تشمل اليوم الفضاء السيبراني والنظام المالي الدولي. هذه المجالات هي التي تشكل الأسس الاستراتيجية للقوة العالمية. وتحدد السيطرة عليها الوصول إلى الموارد الحيوية؛ ومستقبل الإنترنت؛ والمكاسب العديدة التي تترتب على طباعة العملة الاحتياطية العالمية؛ والقدرة على الدفاع ضد طيف واسع من التهديدات الأمنية. وبينما يركّز معظم المحللين على أعراض التنافس -مثل الرسوم الجمركية، وقطع سلاسل توريد أشباه الموصلات، والسباقات التكنولوجية قصيرة المدى- تقوم بكين ببناء القدرات والنفوذ داخل الأنظمة الأساسية التي ستصنع هوية العقود المقبلة. وكان القيام بذلك محوريًا في حلم الرئيس شي جين بينغ باستعادة مركزية الصين على الساحة العالمية. وقد قال شي في العام 2014: "يمكننا أن نلعب دورًا رئيسيًا في بناء الملاعب، حتى منذ البداية، حتى نتمكن من وضع القواعد لألعاب جديدة".
وضعت بكين نفسها في موقع جيّد لخوض هذه المنافسة. وهي تتعامل مع هذه الحدود بمنطق ثابت وكُتيّب إرشادي واضح. وهي تستثمر في القدرات الصلبة اللازمة. وتبني شراكات مع دول أخرى لتزرع نفسها في المؤسسات، وتغمر هذه الهيئات بخبراء ومسؤولين صينيين يخوضون لاحقًا حملات للتغيير. وعندما لا تستطيع استيعاب مؤسسة قائمة، فإنها نقوم ببناء واحدة جديدة. وفي كل هذه الجهود، تُظهر بكين قدرة عالية على التكيّف، حيث تُجرّب منصات مختلفة، وتعيد صياغة مواقفها، وتنشر قدراتها بطرق جديدة.
بدأ صانعو السياسات الأميركيون يستيقظون للتو فقط على حجم النجاح الذي ححقته الصين في بناء القوة في المجالات الأساسية لعالم اليوم. وهم الآن مهددون بتفويت التزام الصين بالهيمنة على عالم الغد. بعبارة أخرى، لا تكتفي الولايات المتحدة بالتخلي عن دورها في النظام الدولي الحالي فحسب، بل تتخلّف أيضًا في معركة تحديد النظام التالي.
عشرون ألف فرسخ تحت البحر
في العام 1872، أرسلت بريطانيا سفينة لاستخراج أول مخزون عالمي من العقد متعددة الفلزّات: تكتلات من رواسب قاع المحيط يمكن أن تحتوي على معادن حيوية مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت. لكن العلماء لم يفترضوا حتى أوائل الستينيات أن هذه العقد ربما تنطوي على فوائد مالية كبيرة. وفي منتصف السبعينيات، ادعت شركة "ديب سي فنتشرز" الأميركية، وهي شركة فرعية لـ"تينيكو"، أنها تستطيع تلبية ما يقرب من كل احتياجات الجيش من النيكل والكوبالت بتعدين قاع المحيط الهادئ.
ولم تحصل "ديب سي فنتشرز" قط على الأذونات التي احتاجتها لجرف كميات ضخمة من العقد، وفي نهاية المطاف طُويت صفحة الشركة. لكن فاعلين دوليين آخرين بدأوا في تلك الأثناء مفاوضات حول حقوق الدول والتزاماتها بشأن محيطات العالم. وبلغت هذه المفاوضات ذروتها في اعتماد "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) 1994. وشملت الاتفاقية قواعد حوكمة للموارد الموجودة في قاع البحار العميقة الواقعة خارج المياه الإقليمية للدول. وأنشأ أطراف الاتفاقية، بتمويل من كبرى شركات التعدين العالمية، "الهيئة الدولية لقاع البحار" لإدارة هذه الموارد.
بدأت الصين بحوثها الخاصة في تعدين أعماق البحار في أواخر السبعينيات. وطوّر علماؤها ومهندسوها نماذج أولية من الغواصات والمكائن القادرة على التعدين، وكذلك مسح قاع المحيط. وفي العام 1990، أسست بكين "هيئة الصين لأبحاث وتطوير الموارد المعدنية في المحيطات"، وهي هيئة تسيطر عليها الدولة تقوم بتنسيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية