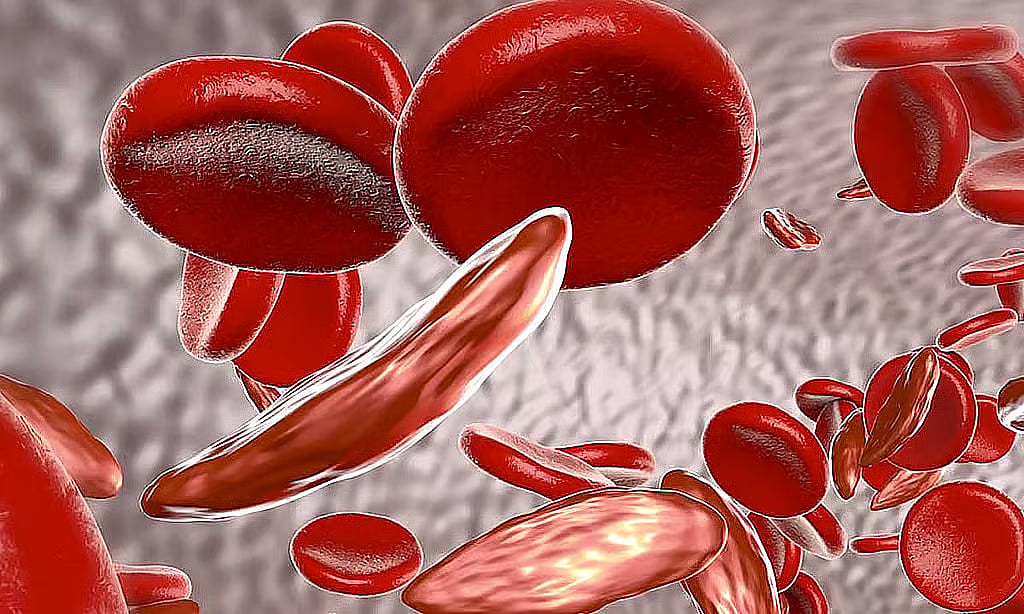لم أكتب بالعربيَّة منذ سنوات. لم يكن ذلك هجرًا للُّغة، بل انشغالًا بلغةٍ أُخْرى: لغة المؤسَّسات، والمفاوضات، والوساطة الدوليَّة -حيث تُوزن الجُمَل بما تُنتج، لا بما تُطرِّز. لكن حين عدتُ إلى المملكة، اكتشفتُ أنَّ العودة ليست إلى المكان وحده، بل إلى الصَّوت- وكأنَّ العربيَّة، في أزمنة التحوُّل، ليست زينة مقال؛ بل أداة تأسيس.
قبل أسبوعين، كنتُ في الدرعيَّة -وبالذَّات في الطريف- لا يلاحقك الماضي بوصفه حنينًا، بل يواجهك بوصفه منهجًا: كيف يُدَار الاختلاف في الجزيرة العربيَّة حتَّى يصير قاعدةً، وكيف تتحوَّل السلطة إلى مؤسَّسات، وكيف تُبنَى الشرعيَّة بوصفها انضباطًا قبل أنْ تكون شعارًا.
رافقتنا في تلك الزيارة طبيبةٌ يابانيَّةٌ مسنًّةٌ، قارئةٌ للتاريخ، بلا عصا سيلفي، ولا شغف باللَّقطة. كانت تحمل دفترًا صغيرًا، وسؤالًا كبيرًا. قالت بهدوءٍ يُحرجك: «أنا لستُ هنا للصور... أنا هنا للمؤسِّس». وحين وقفنا أمام صورة المؤسِّس، انحنت له انحناءةً يابانيَّةً تحيَّةً للبداية. ثمَّ -وكأنَّها تضع ختمًا نهائيًّا على الرحلة- أصرَّت أنْ نزورَ مقبرةَ العود!
هنا يعترفُ الكاتبُ أنَّه ابتسم في داخله من المفارقة الثقافيَّة. زيارةُ المقابر عندنا لها ما لها، وعليها ما عليها، وعند كثيرِينَ موضوعٌ جدليٌّ؛ بينما كانت عندها جزءًا من المنهج. لم تكن زيارةً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة