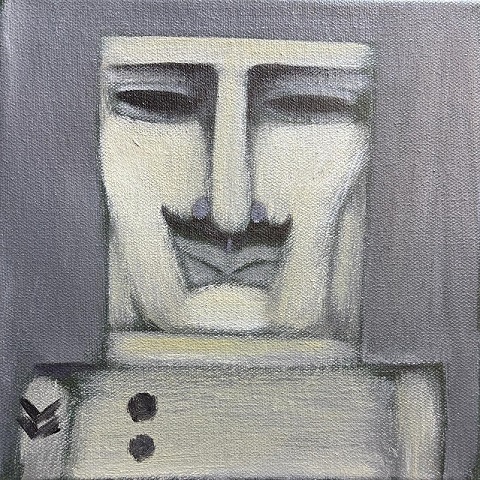الرسومات مهداة من الفنان مصطفى رحمة
كانت الساعة تقترب من العاشرة مساء عندما أقبلت نحو زنزانتنا أصوات أقدام فى أحذية ثقيلة، لم يكن السكون قد ساد العنبر بعد، إذ تتواصل المسامرات والنداءات المتبادلة بين السجناء عبر قضبان «الهوَّايات» الصغيرة بأعلى أبواب الزنزانات، ومع بروز أصوات الأقدام المقتربة من زنزانتنا فى طرقة العنبر عم الصمت. كانت أصوات الأقدام فى الأحذية الثقيلة تعنى أن بوابة العنبر قد فُتحت لأمر طارئ وعاجل ويستدعى إجراءات مشددة.
اتضحت صلصلة حلقة مفاتيح الزنزانات خارج زنزانتنا فاستدارت وجوهنا نحن الأربعة نحو بابها. تبادلنا نظرات التساؤل والريبة، ووقفنا مشدودين بقرب الباب. دار المفتاح المعدنى الكبير فى الكالون، وأسفر انفتاح الباب الأسود الثقيل عن ظهور شاويش العنبر برفقة اثنين من عساكر السجن. وقال الشاويش يحادثنى بصوت عالٍ ونبرة متعجلة: «جهز نفسك بسرعة يادُكتُر حالة مستعجلة فى سجن الحريم!».
سجن الحريم؟! الحريم؟! انشدهت وجوه رفقاء الزنزانة الثلاثة ــ مصطفى وهبة وثروت أبو سعدة وعادل عبدالباقى ــ بينما يحدقون فى وجهى بدهشة، واستثارة، وغبطة، و.. حسد! نعم حسد، فها هو واحد منهم سيذهب إلى الجنة المفقودة، صحيح أنه ذاهب ليرى مريضة فى زنزانة، وربما يكون مرضها مما يحزن ويؤلم، لكنه سيرى غيرها من السجينات المعافيات، واللائى ربما يجد بينهن جميلات، أو غير جميلات، فيكفى أنهن إناث. وياللأنوثة التى لا يُعرف قسوة الحرمان بتغييبها عن عالم الرجال قدر المسجونين.
كنا أربعة فى الزنزانة، ثلاثة منا طلاب جامعة غير متزوجين، أما الرابع الذى يكبرنا بعشر سنوات، فقد كان مُدرِّسًا متزوجًا وأبا لابنتين. صحيح أنه كانت لكل من ثلاثتنا بدايات حب أو أطياف حب، إلا أن السجن بأسواره وقضبان بواباته ونوافذه وعالمه الذكورى، كان يُعرِّى مدى هشاشتنا البشرية كذكور فى عالم بلا إناث. وكان أقسى معاناة دواخلنا هى الشوق إلى الأنثى، كوجود حانٍ ومُعطِّر ومُلطِّف وندى ومُدفئ، وبغيابه يصير الوجود فى عالم السجن أقسى وأخشن وأجف وأبرد. لهذا لم يكن غريبا أن جانبا كبيرا وعميقا من مسامرات سهرنا مكرَّس لاستحضار قصص حبنا أو حب أصدقائنا، بل سيرة الأنوثة فى وعينا ولا وعينا.
أحاديثنا عن الإناث كانت تستحضر وجودهن أطيافا فى أخيلتنا وعواصف فى مشاعرنا وصرخات بلا صوت تناديهن. لكن المُعادِل لكل هذه الاستحضارات لدينا كشبان وطلاب جامعة وسجناء سياسيين، كان لدى السجناء الجنائيين إجراءات عملية مكلفة، أو عالية المخاطرة، تساوى الحياة كلها أحيانا، لمجرد أن يرى السجين منهم أنثاه، أو أى أنثى، خاصة السجناء الذين طالت بهم سنوات الحبس.
كنت مرتبكا وأنا أدور حول نفسى واقفًا وسط الزنزانة وحولى زملاء الحبسة، بينما يتعجلنى الشاويش مُشخشخًا بحلقة المفاتيح. قلت «دقايق ألبس هدومى» إذ كنت أقف على «البورش» حافيًا وفى بيجامة النوم، لكن الشاويش اعترض نافخًا «لا يا دُكتُر.. إنت تيجى كده، البت هاتموت لو اتأخرنا عليها»، وهنا قفز «الروب ديشمبر» لينقذ الموقف، ويمنحنى لمحة من وقار الطبيب يُخفى ابتذال أن يعود مريضًا بل مريضة، وهو فى بيجامة! وهذا الروب ديشمبر كان حكاية من طرائف حبستنا، بل لمحة من العودة إلى طفولة ما، تستحوذ على البشر إذ يصيرون سجناء.
هذا «الروب ديشمبر» كان لا يخص أيًا من أربعة زنزانتنا الذين رسا عليهم الاتهام فى قضية انتفاضة يناير 1977 فى المنصورة، بل هو لوالد زميلنا إيمان يحيى الذى كان ضمن عشرات مَن قُبِض عليهم فى أعقاب يومى الانتفاضة، وخرج بعد شهر تقريبًا. ولأن سجننا بدأ فى ذروة برودة الشتاء أرسل الأب هذا الروب لابنه حتى يتدثر به فى برد السجن الذى كان قارصا حقا. وقد ترك إيمان ذلك الروب الصوفى الأنيق لنا على أن نرده ما إن تخف البرودة.
الروب ديشمبر كان بالنسبة لنا «أبهة» أكثر من كونه رداءً للدفء، فرُحنا نتبادله عندما يفتحون الزنزانات للخروج إلى الحوش وقت الفسحة، ويمشى لابسه واضعًا يديه فى دفء جيبى الروب مربوط الحزام، مشعا بتباهٍ دفين وسط السجناء الذين تلفت أنظارهم هذه الأبهة. وبمنطق «العدالة الاجتماعية» التى كنا نرفع نداءها، وضعنا جدولًا ليحظى كل منا بدور من الدفء والوجاهة داخل هذا الروب. ولم يكن الروب من دورى فى ذلك الليل الذى جاءنى فيه ذلك النداء شبه الخيالى لأكشف على أنثى فى سجن الحريم.
لا أتذكر أى زملاء الزنزانة كان يرتدى الروب فى هذا الوقت، لكننى أتذكر روعة اللحظة التى تنازل بها لابس الروب عن دفئه وأبهته لأرتديه، وكان زملائى لا يساعدوننى فقط فى ارتدائه وربط حزامه وهندمة ياقته، بل تحولوا إلى مساعدين يجهزوننى بأدوات الطبيب وبعض أدوية الطوارئ التى أحملها معى وأنا أغادر «عيادتى» فى الزنزانة الخالية المجاورة فى الساعة الثالثة عصرًا، وقت انتهاء «الفسحة» وبدء غلق الزنزانات.
استقرت السماعة وجهاز الضغط فى الجيب الأيمن للروب مع لمسة ظاهرة تشى بوجودهما، وفى الجيب الأيسر بعض أدوية الطوارئ، أما الجيب الصغير على الصدر فقد استقر به خافض اللسان وميزان الحرارة و«تورش» إضاءة طبى. تم كل ذلك بسرعة، ولم يكن فى هذا التسريع وقت لارتداء حذائى، فخرجت فى الشبشب. وودعنى زملائى وعيونهم تغبطنى على منحة زيارتى للفردوس المفقود! بينما ملامحهم المشدوهة تومئ لى: «ها تحكيلنا.. هه.. ها تحكيلنا؟!».
«ماذا أحكى»؟.. ذهبت ومكثت فى هذه المهمة حوالى ساعة، وعدت إلى زنزانتنا دون الروب ديشمير، واجمًا شاردًا شرود الصدمة، فسجن النساء الذى كان يخايلنا عبر النوافذ الخلفية لزنزانات صفنا، والذى تبدَّى لنا ولغيرنا من النزلاء كحرملك يزخر بالإناث، بستان متعة من رفيف الحوريات وهبات الهوى المتقد. أخيلة كان يعززها فى سجن الرجال ليس شقاء الافتقاد للإناث فقط، بل تؤججها إغراءات الإناث المرئية والمسموعة عبر قضبان نوافذ زنزاناتهن المواجهة ــ على مد البصر ــ لنوافذ زنزانات الرجال، بعد انتهاء «الفسحة» والدخول إلى الزنزانات وإغلاقها.
عادة، وفى الوقت من بعد العصر وحتى ما قبل الغروب، تظل تتطاير عبر قضبان الزنزانات نداءات الرغبة الصريحة والمستترة ما بين الجانبين، ففى الفضاء الذى يصعب تكبيله بين السجنين يتجلى العرض الإيروسى من وراء القضبان. يُفتتَح بصوت أنثى تنادى: «يا واد يا واد.. يا واد يا اللِّى باحبه»، ويرد على صوت الأنثى صوت ذكر من سجن الرجال وبالصيغة نفسها «يا واد يا واد.. يا واد يااللِّى باحبه»، ثم تنطلق المجاهرة «بت يا بطة» وترد بطة «واد يا عربى»، وتدوى المجاهرات بأسماء نسائية وأسماء ذكورية غير معروف إن كانت أسماء حقيقية أم مُدَّعاة. ثم يبدأ التحقق: «شايف إيدى يا واد» وتخرج من بين القضبان يد أنثى تُلعِّب أصابعها، ويرد الواد «شايفها يابت.. شايفة إيدى أنا؟». ويتصاعد الشوف..
فجأة، وعبر تداخل الأصوات بين الجانبين، تدوى زنزانات سجن الرجال بصيحة جماعية جنونية: «هاااااااااه»، فثمة واحدة من سجن النساء عرَّت صدرها ودفعت بنهدها عبر أحد مربعات قضبان نافذة زنزانتها مدلِّلة تنادى «الحلو آهو.. آهو أهو..» فيجيب صوت رجل زاعق بالتياث «قشطااااه قشطاااااه»، وترد الأنثى مربتة على نهدها: «ما لكش فى الطيب نصيب يا واد»، وتتوالى أطياف النهود النافرة من بين القضبان، فيُجَن الرجال الذين عادوا أولادًا «هااااااااااه» صيحة جماعية داوية، لاتعرف إن كانت آهة استوحاش أم استهوال أم كليهما!
يبدو الفضاء بين السجنين كأنما يشتعل بهياج الأصوات، ويوشك على تأجيج حريق انفعالى يصعب إطفاؤه، وتتدخل الإدارة بسرعة لقمع جنون هذا الصخب. تنسحب هاربة مع الصراخ نهود الإناث المطلة من مربعات مابين قضبان نوافذ زنزاناتهن، وتنطلق احتجاجات الذكور: «الله ع المفترى.. الله ع المفترى»، إذ يتردد أن سَجَّانات سجن الحريم عند هذه الذروة، يفتحن زنزانات نوافذ «القشطة» وقد فككن «قوايش» الجلد السميك التى تُحزِّم وسطهن، ويهوين بها جالِدات صدور نجمات ذروة العرض، فتتصاعد صرخات فزعهن والألم، كما نقيق دجاجات بوغتن بهجمة ثعالب ضارية.
وعلى عكس ما تنتهى عروض المسارح والسينمات بإيقاد الأضواء، تنتهى عروض ما وراء القضبان بالإظلام، تنطفئ الأصوات، ويبدأ الأفق إعتامه قرب الغروب. غروب ساكت موحش، أكأب غروب، ذلك الذى يُشاهَد من وراء القضبان زاحفا يمهد لظلمة ليل السجون، وكوابيس نوم السجون. ولعل هذا ما جعلنى خفيفًا مغتبطًا بدعوة تلك الليلة لمناظرة الألم! ففى ثنايا ألم مريضة سجينة كان هناك وعد منحة نادرة.. ندرة إطلال شاب يحس أن داخله كاتبا ينمو بالتجارب، مُرَّة كانت أو حلوة!
أمر واحد كان يقلقنى ويشوش اغتباطى بمنحة هذه التجربة.. إنه امتحانى الطبى فيما أنا ذاهب إليه بسجن النساء، كنت فى السنة النهائية على وشك التخرج، وكان نفورى من الدراسة النظرية فى المراحل الأولى بالكلية قد تحول إلى شغف وجدية فى المرحلة الإكلينيكية، لم أترك فيها جلسة نقاش سريرى على المرضى فى المستشفى إلا وحضَّرت له وحضرته، وصرت أذاكر بحماس، بل بفرح. لهذا بدا دخولى السجن قُبيل امتحان التخرج بشهور قليلة كنقمة، سرعان ما تحولت إلى نعمة.. أعفتنى من تشتت تعدد الانشغالات، فصارت كتب الطب متعتى وشاغلى، ووجدت نفسى أسعد بالاجتهاد فى معالجة مرضى العنبر، حال عدم وجود طبيب السجن، الذى لا يتواجد إلا فى الصباح.
بات الوقت أمامى صافيًا ورحيبًا، ويبدو أننى سجلت نجاحا ما لفت انتباه إدارة السجن، فمنحتنى - وديًا - زنزانة خالية مجاورة لزنزانة أربعتنا، وضعت فيها كتبى وأدواتى الطبية وبعض الأدوية. أقضى فيها وقت فتح الزنزانات، أذاكر وأستقبل المرضى، فصارت هذه الزنزانة عيادة العنبر، وأنا الطبيب! بل وصل الأمر بهذه العيادة وبى، أن خُصِّص لى سجين يعاوننى كتومرجى «واد فهيِّم وحِرك ونضايفى»، على حد تعبير شاويش العنبر، وقد كان «سمير» كذلك بالفعل، برغم أنه بحرفته وقضية سجنه: «نشَّال!».
كان كل ذلك طريفًا، ويحيل سجنى إلى تجربة ممتعة! لكن أن أُستدعَى إلى حالة طارئة فى الليل، وبسجن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق