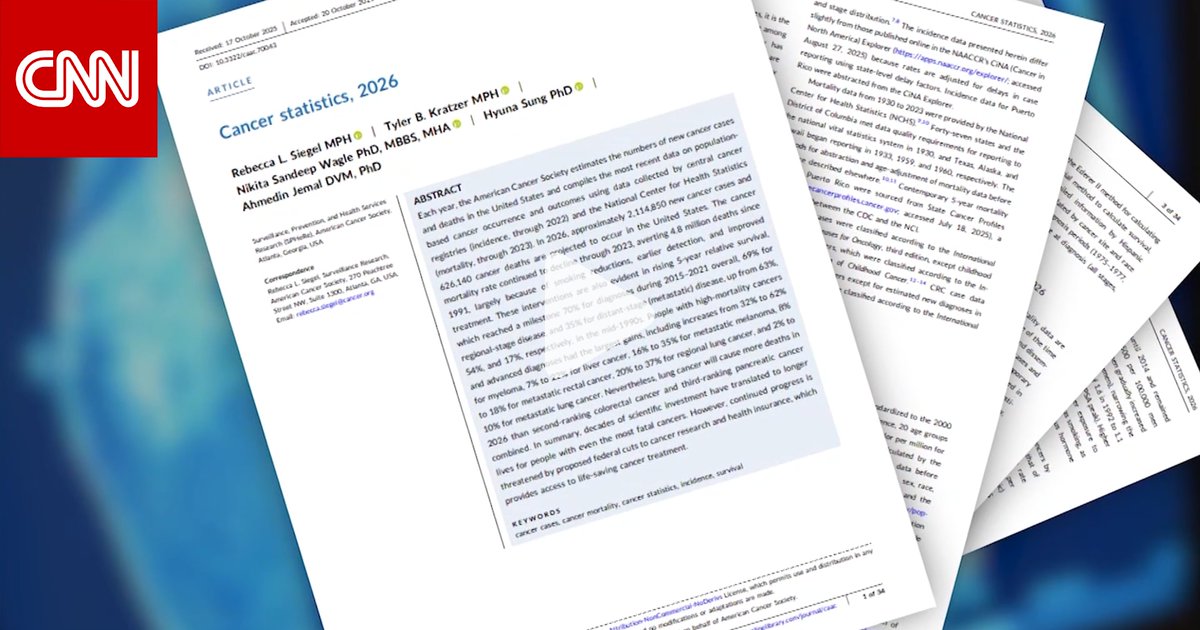مع انتهاءِ العام الأول من ولاية الرئيسِ الأميركي دونالد ترمب الثانية، يتأكد للمراقب أنَّ عودتَه لم تكن مجردَ حدثٍ انتخابي عابر، بل كانت تعبيراً صارخاً عن بلوغ النقمةِ الشعبية ضد المؤسسات التقليدية ذروتها. هذه العودة التي استندت إلى أغلبية صلبة في الكونغرس، منحتِ الرئيسَ ترمب تفويضاً لم يحظَ به الكثير من أسلافه، مما سهَّل عليه اتخاذ قرارات بدت في ظاهرها متمردة على العرف، لكنَّها في جوهرها تعكس دوراً وظيفياً يخدم مصالح عميقة في بنية الدولة الأميركية. ويبدو أن ترمب، بوعي، أو من دونه، يتقمَّص دور القائد الذي تقبل به القوى الفاعلة في الدولة العميقة لتنفيذ ما لا يجرؤ غيره على الاقتراب منه، وهو دور المنفذ الذي يتحمل العبء التاريخي لخطوات كانت تنتظر من يمتلك الجرأة على كسر الجمود المحيط بها. إنَّ المشاهد التي شهدها العالم خلال السنة الأولى من رئاسة ترمب، والتي تم تتويجها بالعملية المباغتة التي انتهت باقتياد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قصره، وصولاً إلى الأراضي الأميركية، إضافة إلى الإصرار على إعادة طرح ملف ضم غرينلاند رغم الممانعة الأوروبية، تشير إلى أنَّنا أمام نمط إداري يُطبق غالباً في المؤسسات الكبرى، سواء كانت تجارية، أو أكاديمية. ففي لحظات الأزمات الهيكلية، يتم استدعاء رئيس تنفيذي بصلاحيات استثنائية للقيام بمهمة محدَّدة المدى، تتمثل في إجراء مذابح إدارية، وتفكيك مراكز قوى قديمة، وإلغاء عقود لأسماء عريقة، بحيث يمهد الأرض لمن سيخلفه للعمل في بيئة مطهرة من الأعباء السابقة. هذا القبول الضمني من أجهزة الدولة لمثل هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط